نجيب محفوظ

عندما احتفلت مصر امس بمئوية المتحف المصري،
الذي يضم كنوز وأسرار الحضارة المصرية القديمة،
وفي الوقت نفسه كا ن يحتفل نجيب محفوظ بدخوله حديقة عامه الثاني والتسعين،
متأملا نصه الفريد وهو ينفتح بقوة على لحظتي البداية والنهاية،
وكأنه يولد للتو،
وكأن كل هذه السنين التي عاشها على ظهر
كوكبنا التعيس قد منحت هذا النص أبوة التاريخ وأمومة الحياة.
في صباح ذكرى ميلاده يرتشف محفوظ
رشفة واحدة من فنجان قهوته «السادة»
ويأخذ نفسا عميقا من إحدى سيجاراته المعدودة،
وربما يطلق ضحكته الرنانة،
وببساطة سوف يهمس لمريديه: أنا أحلم بأنني صرت أثرا،
لذلك ينبغي أن تغادروني حتى تكتمل كينونتي وأبهتي،
فالأثر يتحول الى قيمة بالترك،
وحين ينفك من حبائل المكان والزمان يصبح سؤالا ممتدا في الوجود والحياة.
وبتلقائيته المعهودة،
ربما يرفع محفوظ صوته قليلا: ألم أدخل هذا المتحف،
ألم ألمس بهاءه وقداسته في طفولتي الاولى،
كنت أحفر مجراي الخاص في أزقة النهر الكبير،
لحظتها لا أعرف لماذا تخيلته بلا ضفاف،
أو جدران،
أو أقنعة،
أو صولجان،
لحظتها ربما توهمت أنني الضفة الاخرى وراء هذه الضفاف.
صرخت آنذاك: انا الطفل في صحراء العمر،
لكن صرختي كانت تتكسر تحت خطاي وفوق شفتي،
وأحيانا كانت تتحول الى تمثال من الجرانيت الحي،
تحت اقدامه تجلس «رادوبيس» و«عبث الاقدار» يتأملان «كفاح طيبة»،
وهي تشد الشراع من خيوط الشمس، تجدله في أكف السماء..
هل ولدت وسط هذا الطيف. كان حلمي أن أرى ما تحت قدمي،
لكن لا اعرف كيف زاغ البصر الى الأبعد والأعقد في متاهة الانسان والأشياء والحياة.

اثنان وتسعون عاما أحملها فوق ظهري،
لم أكل أو أيأس،
أو أغير ايقاعي ومزاجي،
أو أبدل خطوة بأخرى..
كنت دائما ميزان نفسي.
في الثلاثية كنت أراقب هذه النفس
وهي تخطو فوق مدارج الحياة،
وتتعثر في لعبة النهوض والانكسار،
لعبة الخير والشر،
وفي «الحرافيش» رفعت النبوت وهشمت «المرآة».
كان لدي دائما «الموديل» أو النموذج،
أعشقه، وأكسوه بهواجسي ودمي ولحمي.
أحيانا أخرجه من عباءة الماضي،
فيغدو هذا الماضي حاضرا شديد التيقظ والإرباك.
واحيانا اخرجه من عباءة الحاضر فيغدو
هو الأخر ماضيا يتراءى فوق حافة الحلم والواقع،
أو فوق حافة الهاوية التي أسميها ربما التاريخ أو الانسان.
يصمت قليلا متأملا غبار سيجارته
وهو يتموج فوق صفحة النيل،
وكأنه ينصت الى أصقاع نفسه: أنا المتحف إذن،
ألم تشاهدوا فنوني وألواني في
«القاهرة 30»
و«ثرثرة فوق النيل»
و«بداية ونهاية»
، ألم تلمسوها بمحبة نزقة في
«السمان والخريف»
و«ميرامار»
و«اللص والكلاب»
و«الطريق»
و«همس الجفون»،
لقد أحببت أبطالي، لم أحجر عليهم،
تركتهم يصنعون مصائرهم بحرية تامة،
ويواجهونها تحت راية وحيدة هي: العدل والحب،
وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
يشرد محفوظ،
ويمعن في خطوط يديه الواهنتين: أكملوا نقاشاتكم،
سوف أنصرف الان،
الوقت متأخر،
هناك أحلام تنتظرني،
هناك سهام
من المؤكد أنها سوف تطيش حين تجرحني بمحبة خالصة.

الذي يضم كنوز وأسرار الحضارة المصرية القديمة،
وفي الوقت نفسه كا ن يحتفل نجيب محفوظ بدخوله حديقة عامه الثاني والتسعين،
متأملا نصه الفريد وهو ينفتح بقوة على لحظتي البداية والنهاية،
وكأنه يولد للتو،
وكأن كل هذه السنين التي عاشها على ظهر
كوكبنا التعيس قد منحت هذا النص أبوة التاريخ وأمومة الحياة.
في صباح ذكرى ميلاده يرتشف محفوظ
رشفة واحدة من فنجان قهوته «السادة»
ويأخذ نفسا عميقا من إحدى سيجاراته المعدودة،
وربما يطلق ضحكته الرنانة،
وببساطة سوف يهمس لمريديه: أنا أحلم بأنني صرت أثرا،
لذلك ينبغي أن تغادروني حتى تكتمل كينونتي وأبهتي،
فالأثر يتحول الى قيمة بالترك،
وحين ينفك من حبائل المكان والزمان يصبح سؤالا ممتدا في الوجود والحياة.
وبتلقائيته المعهودة،
ربما يرفع محفوظ صوته قليلا: ألم أدخل هذا المتحف،
ألم ألمس بهاءه وقداسته في طفولتي الاولى،
كنت أحفر مجراي الخاص في أزقة النهر الكبير،
لحظتها لا أعرف لماذا تخيلته بلا ضفاف،
أو جدران،
أو أقنعة،
أو صولجان،
لحظتها ربما توهمت أنني الضفة الاخرى وراء هذه الضفاف.
صرخت آنذاك: انا الطفل في صحراء العمر،
لكن صرختي كانت تتكسر تحت خطاي وفوق شفتي،
وأحيانا كانت تتحول الى تمثال من الجرانيت الحي،
تحت اقدامه تجلس «رادوبيس» و«عبث الاقدار» يتأملان «كفاح طيبة»،
وهي تشد الشراع من خيوط الشمس، تجدله في أكف السماء..
هل ولدت وسط هذا الطيف. كان حلمي أن أرى ما تحت قدمي،
لكن لا اعرف كيف زاغ البصر الى الأبعد والأعقد في متاهة الانسان والأشياء والحياة.

اثنان وتسعون عاما أحملها فوق ظهري،
لم أكل أو أيأس،
أو أغير ايقاعي ومزاجي،
أو أبدل خطوة بأخرى..
كنت دائما ميزان نفسي.
في الثلاثية كنت أراقب هذه النفس
وهي تخطو فوق مدارج الحياة،
وتتعثر في لعبة النهوض والانكسار،
لعبة الخير والشر،
وفي «الحرافيش» رفعت النبوت وهشمت «المرآة».
كان لدي دائما «الموديل» أو النموذج،
أعشقه، وأكسوه بهواجسي ودمي ولحمي.
أحيانا أخرجه من عباءة الماضي،
فيغدو هذا الماضي حاضرا شديد التيقظ والإرباك.
واحيانا اخرجه من عباءة الحاضر فيغدو
هو الأخر ماضيا يتراءى فوق حافة الحلم والواقع،
أو فوق حافة الهاوية التي أسميها ربما التاريخ أو الانسان.
يصمت قليلا متأملا غبار سيجارته
وهو يتموج فوق صفحة النيل،
وكأنه ينصت الى أصقاع نفسه: أنا المتحف إذن،
ألم تشاهدوا فنوني وألواني في
«القاهرة 30»
و«ثرثرة فوق النيل»
و«بداية ونهاية»
، ألم تلمسوها بمحبة نزقة في
«السمان والخريف»
و«ميرامار»
و«اللص والكلاب»
و«الطريق»
و«همس الجفون»،
لقد أحببت أبطالي، لم أحجر عليهم،
تركتهم يصنعون مصائرهم بحرية تامة،
ويواجهونها تحت راية وحيدة هي: العدل والحب،
وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
يشرد محفوظ،
ويمعن في خطوط يديه الواهنتين: أكملوا نقاشاتكم،
سوف أنصرف الان،
الوقت متأخر،
هناك أحلام تنتظرني،
هناك سهام
من المؤكد أنها سوف تطيش حين تجرحني بمحبة خالصة.







.jpg)















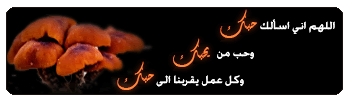
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق